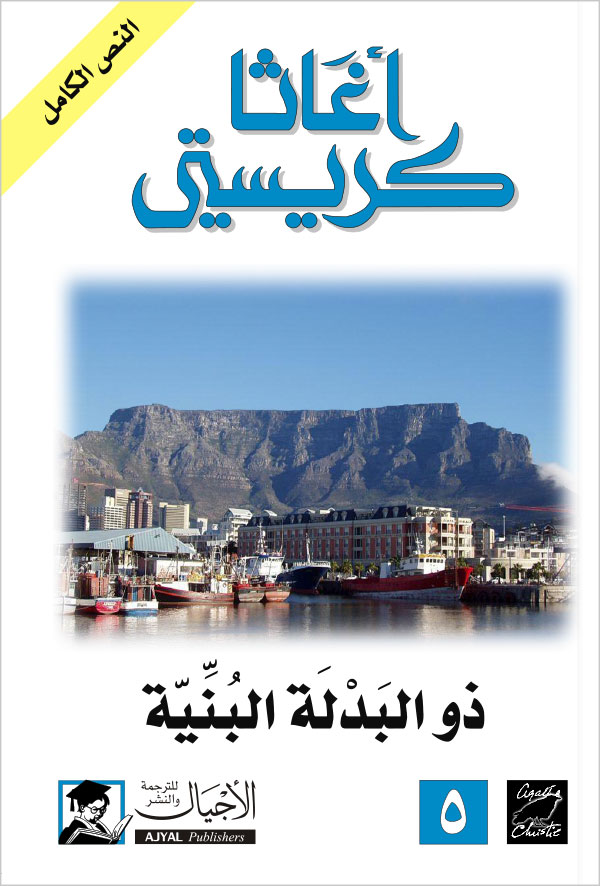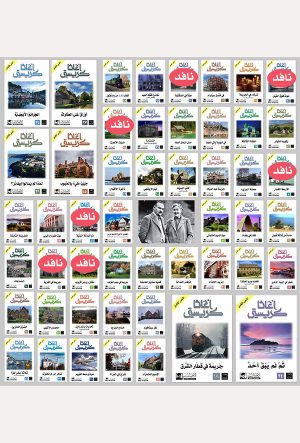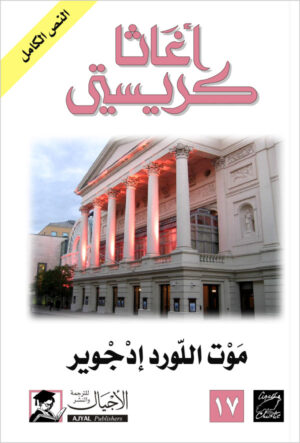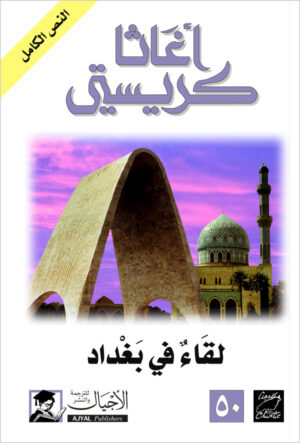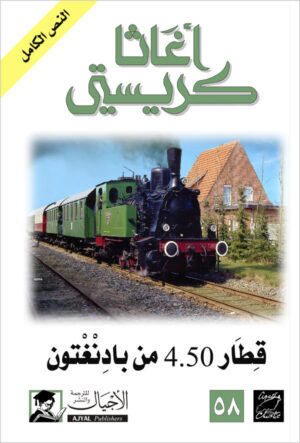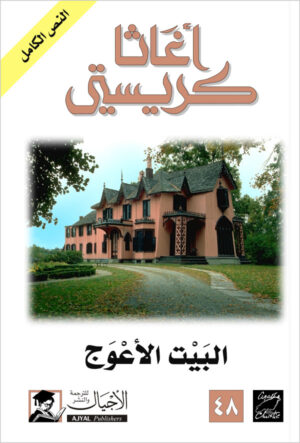ذو البدلة البنية
30.00 ر.س
لقد جاءت آن إلى لندن بحثاً عن المغامرة.
وقد عثرت عليها على الفور… على رصيف قطار الأنفاق في محطة الهايد بارك. هناك، حيث تراجع الرجل النحيل مذعوراً ليسقط على قضبان القطار ويموت بالصعقة الكهربائية.
الشرطة يقولون إن الوفاة حادث، ولكن آن غير مقتنعة. وعلى أية حال: مَن كان الرجل ذو البدلة البنية الذي انكبّ على الجثة لفحصها؟ وما هي تلك الرسالة الغريبة التي سقطت منه وهو يولي هارباً؟
نعتذر من قرائنا الكرام لكن هذا الصنف غير متوفر حالياً بسبب نفاد الكمية.